صلة الإنسان بالمال لها مراتب: حال حياته، وحال وفاته، ففي حياة الإنسان هو وكيل في هذا المال، أعطاه الله تعالى الحرية في الكسب والإنفاق، ولكن هذه الحرية مشروطة بشرطين أساسيين أن يكون المال من كسب مشروع، ومن مصدر حلال، وكذلك أن يكون الإنفاق في أوجهه المشروعة، قال صلوات ربي وسلامه عليه: «يقول ابن آدم: مالي.. مالي، قال صلى الله عليه وسلم: وهل لك من مالك يا ابن ادم إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت» رواه مسلم.
وقد يظن بعض الناس لجهلهم أنهم يملكون الحرية المطلقة في أن يفعلوا في أموالهم ما يشاؤون دون حسيب، أو رقيب، بل قد يظن البعض منهم أن لهم الحق في أن يبالغوا في التصرف في هذا المال أخذًا وعطاءً، فيخالفوا شرع الله تعالى، وبهذا الفهم الخاطئ أو المنحرف قد يقعون في الظلم لبعض أبنائهم، فيظلمون بعض أبنائهم، حين يحابون البعض منهم على حساب الآخرين، فمثلًا هناك من يفضل الذكور من الأبناء على البنات، فيتمتع زوجات الأبناء، ويحرم البنات بحجة أنهن تحت أزواج أغراب، ونسي هذا وأمثاله أن أبناءهم الذين من أصلابهم متزوجون من زوجات أغراب، وهم بهذا يمتعون زوجات أبنائهم ويحرمون بناتهم، وفي هذا ظلم بَيِّن لا يرضي الله تعالى، وسوف يخلق في نفوس البنات الكراهية والبغضاء، وسوف تتقطع أواصر القربى والمحبة. إنها جاهلية ما أنزل الله تعالى بها من سلطان.
إن الله تعالى قد نظم علاقة الإنسان بهذا المال حال حياته، وحال وفاته، أما في حال حياته، فله أن يهب أبناءه ما يشاء من العطيات، وعليه أن يساوي بينهم في العطية، وإذا أراد أن يزيد في أعطياته لبعضهم لعذر ما، فعليه أن يستشير أبناءه، فإن قبلوا فلا حرج في ذلك، أمَّا بعد وفاته فيعود المال إلى صاحب المال (الأصيل) وهو الله تعالى، وإن ملكية المال والحرية في التصرف فيه بالعطاء والمنع يعود كل ذلك إليه سبحانه، فهو المالك الحقيقي للمال، وبموت الإنسان، وهو الوكيل في هذا عن الله تعالى حال حياة الإنسان، وفي هذه الحالة تنتهي إرادة الإنسان في التصرف في المال، ويخضع الإنسان إلى حكم الله تعالى، وبذلك يوزع المال بحسب شرع الله تعالى، والله سبحانه لا يظلم أحدًا، ورضا العباد بما شرّعه الله تعالى عبادة في حد ذاتها، ويخضع المسلم لله تعالى وفق عقد الإيمان الذي نشأ بين العبد وخالقه سبحانه، حتى ولو ظهر ما يعتقده البعض مخالفة في المعاملة بين الذكور والإناث، وحينما يعلم العبد الحكمة من توزيع المال (الإرث) بعد وفاة صاحبه بهذه الكيفية، وأن ما تفعله الشريعة، هو العدل المطلق، وليس بالضرورة هو المساواة التي ينشدها الناس، ومعلوم أن كل عدل مساواة، وليس بالضرورة كل مساواة عدل، لأنه في العدل مراعاة للفوارق، وصلة الوارث بالمورث، فالعدل موجود في قسمة صاحب المال (الأصيل) هو الله تعالى، أمَّا المطالبون بالمساواة بين الذكور والإناث في جميع أحوالهم، فهو ظلم بَيِّنْ، وفيه خروج عن شريعة الله تعالى، أمَّا العدالة ففيها مراعاة للحقوق والواجبات، ومن يحاول أن يتعالى على منهج الله تعالى لأن فيه افتئات على شرع الله تعالى، واستبداد كل بالرأي، ولقد اتصلت بي إحدى القارئات منذ زمن، وقالت إن أباها غني بالغ الثراء، ولكنه يعطي أبناءه من الذكور ولا يعطيها وأخواتها شيئًا، وحين تسأله بناته: لِمَ يفعل ذلك ويحرم بناته من هذا المال؟ فيحتج بحجة باطلة بأنه لا يريد أن يذهب ماله إلى أزواج بناته، وكانت تقول له: كيف تؤثر زوجات أبنائك وتحرم بناتك.. أين العدل في هذا؟!
وطلبت مني ان أوجه نصيحة إلى والدها، عن موقف الإسلام من فعله هذا، وتذكرت قصة أحد الصحابة على عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) حين نحل واحدًا من أبنائه نحلة، وأبت زوجه ذلك إلا أن يشهد على ذلك رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، فسأله رسول الله (صلى الله عليه وسلم): يا بشر ألك ولد سوى هذا؟ قال: نعم، قال: أكلهم وهبت لهم مثل هذا؟ قال: لا، قال: فلا تشهدني إذًا، فإني لا أشهد على جور. رواه الإمام مسلم في صحيحه.
إن الإسلام يرفض الظلم وينهى عن الجور، والأولاد من الذكور والإناث أبناء لأبٍ واحد، وعلى الآباء ألا يفاضلوا بينهم في العطاء
أما تصرف الورثة في المال بعد وفاة صاحبه، فهو شرع شرعه الله تعالى وأمرنا باتباعه وعدم الخروج عليه لأن الحكمة في توزيع الميراث بهذه الكيفية التي ذكرها الله تعالى في القرآن قد نعلمها وقد نجهلها، وإن التزامنا بما شرعه الله تعالى هي طاعة نتعبد بها، ولو انتظرنا المجهول حتى يكون معلومًا لنفعله لأصبحنا نطيع الحكمة لا الحكيم سبحانه وتعالى.
هذا هو الإسلام دين العدل، والقسطاس المستقيم، وتلك هي أهواء البشر.


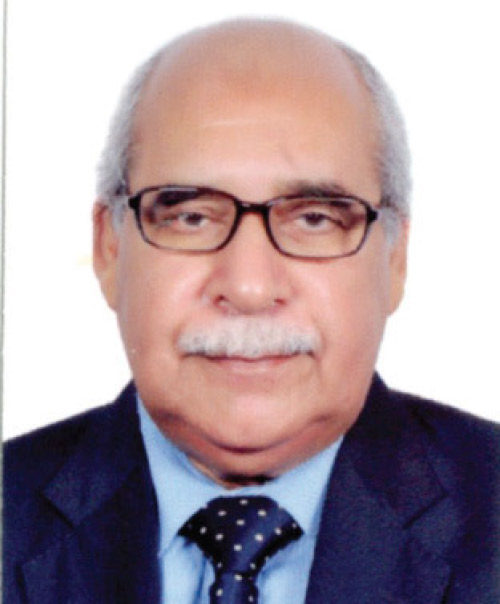






هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك